
17 فبراير التعرف على الغير بوصفه واجباً دينياً
ماذا لو قاربنا «الإيمان الديني كعامل مؤسس للتواصل الخلاّق» بين الأديان والثقافات؟
سوف نأتي بالجواب على هذا السؤال من منفسح فرضية مؤداها: ضرورة التعرُّف على الغير كأساس سابق للحوار معه. نقصد بـ«التعرُّف»؛ إرادة المعرفة المسبوقة بصدق النية وصفاء السريرة، تحقيقاً لمنظومة فهم متبادل بين الأديان، مؤيدة بالعقل ومسدَّدة بالإيمان والأخلاق.
منظومة ترى إلى المعرفة بوصفها الغاية القصوى للإيمان الديني، ولا يمكن تحصيلها إلا بالسعي والبذل والاجتهاد والمجاهدة. وحين يأخذ التعرُّف هذا المسرى، يصبح شأناً ذاتياً لدى قاصد المعرفة. فهذا «القاصد» ـ سواء كان فرداً أو جماعةً دينية ـ مدركٌ أن ما ينبغي له من أفعال لأجل التعرُّف، يدخل ضمن سيريَّة تحويل المجهول إلى معروف. ولا تنهض مثل هذه السيرية إلا بتلازم فعلي بين القول والعمل، بين المؤسسات والخطاب الذي يسبقها.
فإذا كان فعل القول بحد ذاته معرفة تصوغ بيان التعرُّف، فإنه لا يبلغ كماله ما لم تسبقه النية الحسنة ورحمانية المقصد. أما فعل العمل فهو مصداق النية، الذي يفصح عن صفات الفاعل بالتخلُّق وتهذيب النفس وإيثار الغير، فتكون النتيجة أن ترى الغير في نفسك وترى نفسك في الغير.
فلو حققت هذا المقام، تكون قد قطعت مسافة التباين المكتظة بالريب، بين نفسك ونفسك. فإنه لكي تجري رحلة الأنا والغير مجرى التعرُّف، فلا مناص من قيامها على الصفاء ورحمانية الاختلاف. وحين يأخذ التعرُّف سبيله العملي في ميادين الاختلاف يتحقق الوصل، وأفضل درجات الوصل ما نشأ ونما في متسعات الغيرية.
فالتعرُّف هو الوليد الشرعي للتغاير. وخارج الواقع المتعدد للحضارات وثقافات الأديان، يصعب تظهير هذه الأطروحة إلا في حدود نظر كل ثقافة دينية في مرآة نفسها، ذلك أن الذين يقطنون منازل الأحادية لا يرون إلا صورتهم، وحين يتكلمون لا يسمعون إلا أصداء الكلمات التي قالوها في محافلهم المغلقة.
التعرُّف بهذه الدلالة، هو قضية أخلاقية وعقلانية ودينية بامتياز. وهو قضية تتعالى على التحيُّزات والهويات، وتتصل بها في الآن عينه. إنها متعالية، لأنها تستمد غذاءَها وقوتها من الإيمان بضرورة معرفة الغير.
وهو قضية متصلة، لأنها تهتم بتحيُّز كل جماعة لهويتها، بحكم كون هذا التحيُّز هو الذي حمل هذه الجماعة أو تلك، إلى التعرُّف على نظيرتها. فالتعرُّف الآتي من مقام التحيُّز ليس عيباً ولا منقصة، وإنما هو إقرار بحقيقة الاختلاف والتنوع التي يزخر بها العالم. بل أكثر.
فإن التعرُّف من جانب المتحيِّزين، هو من بديهيات حضورهم في جدلية العيش المشترك. وبسبب من قيامه على هذا الجمع الخلاّق بين تعاليه على العصبية وتحيّزه للهويات الذاتية، يمكن أن ينفتح السبيل عن طريق التعرّف، على تواصل خيِّرٍ وبناءٍ بين الأديان والثقافات على تنوعها واختلافها. من الجائز بطبيعة الأمر، أن يبدأ التعرُّف من دائرة التحيز، لكن التحيُّز الذي نعنيه هو الذي يحمل في داخله الاستعداد للأخذ والعطاء، انطلاقاً من التفاعل والخيرية المتبادلة مع الغير.
بهذا يغدو التعرف مساراً نابعاً من ذات المتحيِّز.. يفيض على الغير بما لديه من جميل، ثم ليدفع بهذا الغير إلى إفاضة معاكسة، هي أدنى إلى رد الجميل بالجميل.
فالتعرُّف بمعناه القرآني، هو في حقيقته تظهير الدفع نحو الأحسن، ذلك أن الدفع التعرُّفي هو أدنى إلى حركة جوهرية تمحو الجهل بالعلم، ثم لتجعل أرض التواصل بين الناس على نشأة الحب والرحمانية والعدل. فالحب كما تقرر الحكمة العملية، مثل الفهم، يزداد اتساعاً وفطنة من تدبُّر الحقائق الكثيرة والعناية بها. وليس أولى من الأديان، وأديان الوحي الإلهي خاصة، من الأخذ بفضيلة التعرِّف. وعند هذه الفاصلة لا تبدو أوَّلية الأخذ بهذه الفضيلة متعلقة فقط بحكم واجبيتها الدينية، وإنما أيضاً وأساساً من جهة كونها قضية أخلاقية كلية.
وفي مقام حوار الأديان الذي يشهدُ حساسية خاصة اليوم، تبدو الصورة الإشكالية ذات بعد معرفي من الدرجة الأولى. فلو دخلنا في تأصيل هذا البعد، لوجدنا أن من لوازم الحوار اقتران الإيمان بالمعرفة. فلا يستوي التحاور الخلاق، ما لم تتلازم هاتان القيمتان لتغدوا معاً أساس كل لقاء، إذ إن أياً منهما تُسدِّد الأخرى وتؤيدها بما لدى المتحاورين من مبانٍ أخلاقية، ويقينيات دينية، تعزز سعيهم نحو التعرُّف.
ما يدعو إلى التفاؤل هنا، أن المنطق الذي يحكم الشخص المتديِّن داخل دين ما، لجهة ما يبذله من جهود نفسية وروحية وفكرية من أجل تمتين ارتباطه المعرفي بدينه، هو نفسه المنطق الذي يحكم الشخص إياه ليبذل الجهد اللازم نحو التعرُّف على دين غيره، ذلك أن الأمر يستلزم في هذه الحال، سَيْريّة نشاط مدفوعة بالتبصُّر الخلقي وبالإيمان الديني إياه، وهو ما تنكشف آثاره من خلال الإيمان بالغير كنظير في النوع الإنساني، والتعرُّف على هذا النظير بوصفه شريكاً في رحلة البناء الحضاري.
الإيمان والمعرفة، ها هنا لا يتجزءان ولا ينفصلان. والمؤمن المنتمي إلى دين أو مذهب معين، يحتاج إيمانه إلى التعرُّف على ما يؤمن به، لكي يثبِّت في قلبه وعقله، الدين الذي ينتمي إليه. حتى المؤمن المستجد، أي الذي اعتنق ديناً جديداً (New Born) يرفض .
ـ كما يقول المفكر الفرنسي أوليفييه روا ـ أن يُصنََف إيمانه ـ كما يفعل الأنثروبولوجيون ـ ضمن خانة نظام رمزي ثقافي، كسائر الأنظمة الرمزية الثقافية. فالأمر عنده يتعلق بحقيقة واقعية عيانية مطلقة. أما إدارك هذه الحقيقة معرفياً، فيعود إلى عملية تدريجية تجري في إطار الشروط الحاكمة على الجغرافيا الدينية، التي يعيش ويمارس تديُّنه فيها.
لأن الحقيقة المطلقة التي آمن بها ذلك «المؤمن المستجد»، تبقى الأساس الذي يقوم عليه حضوره في الوجود. وهذه الحالة هي التي يطلق عليها اللاهوتي البروتستانتي الألماني كارل بارث، عبارة “قفزة الإيمان” (Le Saut La Foi)، التي تؤلف الإيمان الديني عند ذاك الصّنف من المؤمنين. وقد أثبت بعض التيارات الدينية الفلسفية المسيحية، مثل التوماوية (Thomisme، نسبة إلى توما الإكويني)، غياب التضاد بين المعرفة والإيمان، بل إنهما معاً يقويان بعضهما.
حين يكون مقتضى التعرّف، هو التلازم الوطيد بين الإيمان والمعرفة، تكون حرية المتعرف هي أول حاصل لمثل هذا التلازم، إذ بهذه الحرية المحصَّلة سوف يفارق خشيته وتريُّبه. كما أنه يغادر ظنونه الباطلة بأن اللقاء مع الثقافة المقابلة، قد يلحق الأذى بثقافته الدينية وإيمانه.
فالحرية التي يجري تحصيلها بفضل هذا التلازم، سوف تدفع كلا من فريقي التعرف، إلى مغادرة مخاوفه وظنونه. ثم إن الحرية ستمنحه الثقة بأن دخوله إلى الحقول التي يجري فيها استكشاف ما هو مجهول بالنسبة إليه، إنما هو عملية ضرورية لتحصين معرفته وإيمانه من شوائب الجهل. وبهذا السياق يصبح دخول فضاء التعرّف واجبا، يفتح على سفر إدراكي يعود بحصاده الوفير لمصلحة المتعرِّف نفسه.
لكن الفضيلة العليا للتعرف لا تتوقف على تنوير مساحات العتمة التي تحجب بصيرة المتحاورين وحسب، بل هي تمتد بفضائلها لتغمر بأنوار المعرفة كل من يمضي إليها أو يأخذ بناصيتها. وكلما مضى المتعرِّف إلى لقاء نظيره على خط الرحمانية، كلما انقشعت عن نفسه غمامة الجهل، فعرف نفسه وعرف النظير في عين الوقت.
(محمود حيدر)

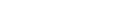

Sorry, the comment form is closed at this time.